استعمل مربع البحث في الاسفل لمزيد من المواضيع
سريع للبحث عن مواضيع في المنتدى
-
09-24-2014, 12:03 PM بتوقيت الجزائر
#1
ابتكارات عربية.. طواحين وساعات مائية! - ثقف نفسك
عنوان الموضوع : ابتكارات عربية.. طواحين وساعات مائية! - ثقف نفسك
كاتب الموضوع : amira
مقدم من طرف منتديات ايمازيغن
ابتكارات عربية.. طواحين وساعات مائية!
خالد عزب
اهتم المسلمون بالماء؛ فهو عصب الحياة، وعامل حيوي لقيام الحضارات، ولذا نجد علماء السياسة الشرعية يشترطون في اختيار مواقع المدن أن يجلب إليها الماء أو أن يكون البلد على نهر أو بإزائه عيون عذبة، وتدين العاصمة الأسبانية مدريد بفضل سقياها وريعها بل وحياتها كلها إلى نظام مبتكر، عرف المسلمون كيف يتقدمون به تقدمًا عظيمًا جديرًا بالإعجاب؛ إذ جلبوا الماء إلى المدينة من على بعد يتراوح بين سبعة واثني عشر كيلو مترات بواسطة شبكة فريدة من نوعها، وهي تتألف من قناة ضخمة تعتبر هي "الأم"، ومنها تتفرع في داخل المدينة شبكة معقدة من قنوات صغيرة فرعية. وفي كل "عقدة" يتجمع عندها عدد من تلك الفروع يقام خزان أو مستودع يجتهد في حمايته ووقايته بالطوب والفخار، وهذه الخزانات هي التي يتحكم منها المهندسون والخبراء في توزيع الماء توزيعًا عادلاً بين الأحياء والمنازل والحدائق العامة والخاصة، وتُبنى عليها صهاريج مقفلة بأبواب وقضبان من الحديد ولا يسمح بدخولها إلا "للقنواتي" الذي يوكل إليه الصهريج ويكون مسئولاً عنه، ويحتفظ بمفتاحه، وهناك صهاريج عامة في الشوارع لسقيا الناس والبيوت، وتكون أحيانًا على ظهر الأرض وأحيانًا أخرى في باطن الأرض إذا كانت القناة التي تمده على عمق شديد، وحينئذ لا يوصل إليها إلا بسلالم تصل في بعض الأحيان إلى نحو ستين درجة.
ويتضح لنا مما سبق ذكره أنه لم يكن من الغريب أن يطلق الأندلسيون على مدينتهم الجديدة لفظًا مثل مجريط الذي حرف بعد ذلك إلى مدريد، وهو مركب من "مجرى" العربية ومن تلك النهاية اللاتينية الدارجة (-يط) التي تدل على التكثير، فمعنى الكلمة إذن "المدينة التي تكثر فيها المجاري"، والإشارة هنا إلى المجاري أو القنوات المائية الجوفية التي كانت تحمل الماء إلى سكان المدينة، واستخدم العثمانيون نفس الأسلوب في إيصال المياه النظيفة إلى الجوامع والحمامات والبيوت في بلغراد، الأمر الذي جعلها تمتاز عن بقية المدن الأوروبية بشبكة المياه العذبة آنذاك.
آلات رفع المياه:
طوَّر المسلمون آلات رفع المياه ومنها الساقية، غير أن أبرز ما ابتكروه في هذا المجال مضخة المكبس التي ذكرها الجزري في كتابه "الحيل الجامع بين العلم والعمل"، وقد تُرْجِم هذا الكتاب إلى كل اللغات الأوروبية تحت اسم (الحيل الهندسية)، ومضخة الجزري عبارة عن آلة معدنية تدار بقوة الريح أو بواسطة حيوان يدور بحركة دائرية.. وكان الهدف منها أن ترفع المياه من الآبار العميقة إلى سطح الأرض، وكذلك كانت تستعمل في رفع المياه من منسوب النهر إذا كان منخفضًا إلى الأماكن العليا مثل جبل المقطم في مصر، وقد جاء في المراجع أنها تستطيع ضخ الماء إلى أن يبلغ ثلاثة وثلاثين قدمًا.. أي حوالي عشرة أمتار وهو ما يعادل ارتفاع مبنى يتألف من ثلاثة أو أربعة طوابق.. وتنصب المضخة فوق سطح الماء مباشرة بحيث يكون عمود الشفط مغمورًا فيه.. وهي تتكون من ماسورتين متقابلتين في كل منها ذراع يحمل مكبسًا أسطوانيًّا.. فإذا كانت إحدى الماسورتين في حالة كبس (اليسرى) فإن الثانية تكون في حالة شفط، ولتأمين هذه الحركة المتقابلة المضادة في نفس الوقت يوجد قرص دائري مسنن قد ثبت فيه كل من الذراعين بعيدًا عن المركز.. ويدار هذا القرص بوساطة تروس متصلة بعامود الحركة المركزي، وهناك ثلاثة صمامات على كل مضخة تسمح باتجاه المياه من أسفل إلى أعلى ولا تسمح بعودتها في الطريق العكسي.. هذا التصميم العبقري لم يكن معروفًا لدى الرومان والإغريق.. وهو اختراع إسلامي صميم. ولا يزال مبدأ مضخة المكبس مستعملاً حتى الوقت الحاضر في جميع مضخات المكبس التي تعمل باليد، وهي منتشرة في كثير من القرى في العالم أجمع.
وهذه المضخة هي الفكرة الرئيسية التي بنيت عليها جميع المضخات المتطورة في عصرنا الحاضر والمحركات الآلية كلها ابتداء من المحرك البخاري إلى محرك الاحتراق الداخلي الذي يعمل بالبنزين. والفكرة الرائدة التي أدخلها الجزري هي استعماله مكبسين وأسطوانتين يعملان بشكل متقابل وبصورة متوازية.. ثم نقل الحركة الناتجة وتحويلها من حركة خطية إلى حركة دائرية بواسطة نظام يعتمد استعمال التروس المسننة، وهو ما يطبق حاليًا في جميع المحركات العصرية.
الطواحين المائية:
عرف المسلمون استغلال قوة جريان المياه كطاقة متجددة، فيذكر القزويني "أن أهل الموصل انتفعوا بدجلة انتفاعًا كثيرًا مثل شق القناة منها، ونصب النواعير على الماء يديرها الماء نفسه، ونصب العربات وهي الطواحين التي يديرها الماء في وسط دجلة في سفينة وتنقل من موضع إلى موضع"، ويشير هذا النص إلى استغلال الماء الجاري في الأنهار والقنوات المتفرعة منها في إدارة الطواحين التي تعمل بالماء كطاقة حركية مفيدة، وانتشرت هذه الظاهرة في المدن التي أمكن عملها على أنهارها، ولعل أشهرها فاس التي يذكر الحميري عنها ما يلي: "وفيها أرحاء للماء نحو ثلاثمائة وستين رحى يضمها السور". ووصف لنا ابن عبد البر طاحون ماء عجيب بمرند بإقليم أذربيجان بقوله: (وبها طاحون تدور بالماء الواقف وهو من أعاجيب البلاد والزمان والعمارة، وذلك أن هذا الطاحون حجران لهما فراشان، كل فراش يدور بمائه ويدير حجره الأعلى من حجريه، فيطحن الحب، والفراشان داخلان في جانبي قبو فيه من الماء المخزون المحقون نحو من قامة عمقًا ومن ستة أذرع في مثلها وسعًا، وفي وسط هذا القبو عمود ممدود كالجسر في عرض القبو داخل في جداريه من ها هنا وها هنا، وعليه أعلى العمود الممدود برابخ رصاص محكمة الوصل موصولة بعضها ببعض قطعة واحدة مفتوحة الحلقوم منعطفة على العمود من وجه الماء، والحلق الواحد منها مفتوح فيه هندسة يمتص بها الماء عن نحو نصف ذراع فيرفعه فيه محمولاً جاريًا حتى يتدلى بقوة في الحلقوم الآخر، وهذا الحلقوم مرتفع عن وجه الماء بقدر معلوم يخر منه الماء فيقع على أرياش الفراش، فيدور فيه الفراش ويدير الحجر ويصل الماء بعد وقوعه على الفراش إلى الماء بعينه، وكذلك بفعل بربخ آخر ملاصق لهذا البربخ وهو مثله في الطول والسعة ومخالف له في الحلقوم، فإن هذا يرفع الماء من حيث يصبه وهذا يرفعه من حيث يصبه الآخر والماء واحد صاعد ومنحدر أبدًا لا ينقص ولا يزيد ولا يتحرك إلا بامتصاص هذين الحلقومين للماء بالإخلاف وصبهما له كذلك، وهذا مثال القبو والماء والعمود والبربخين فافهم ذلك"، ومثل هذا النموذج نحن في حاجة إلى صناعة مثيل له، وخاصة أن ابن عبر البر أرفق مع شرحه له رسمًا أفقيًّا توضيحيًّا، ويمكننا الاستفادة منه وتطويره في عصرنا الحاضر، خاصة مع تصاعد الدعوة إلى استغلال الطاقة المتجددة كمصدر رخيص ونظيف للطاقة.
الساعات المائية:
اهتم المشارقة والمغاربة في العالم الإسلامي بالتنافس العلمي، وهناك عدد من العلماء يحملون اسم ابن الساعاتي، منهم: علي بن محمد بن رستم الخراساني (ت 406هـ/ 1208م) المولود بدمشق، وكان أبوه يعمل بالساعات، وكذلك أخوه فخر الدين رضوان المُتَوفى عام (618هـ/ 1221م)، وهو الذي أصلح الساعة التي كان والده أبو الحسن أعاد بناءها عام (564هـ/ 1168م) في باب جيرون بالجامع الأموي بعد أن احترقت عام 562هـ/1203م وهو المقصود هنا، وهو صاحب كتاب (عمل الساعات والعمل بها) الذي ألف عام 600هـ/1203م. وما دفع المسلمين إلى الاهتمام بصناعة الساعات وتطويرها هو أن اليوم يحتوي على خمسة مواقيت للصلاة، ولا بد لكي يحقق المسلم ما يصبو إليه أن يؤدي فريضته في الوقت المعين. ومن هنا نفسر وصول أخبار الساعة المائية التي شيدت بظاهر الجامع الأموي بدمشق أواسط القرن السادس الهجري، وبظاهر المدرسة المستنصرية ببغداد أيام الرشيد ابن المأمون (630 - 640هـ/ 1232م - 1240م). وقد وصلنا نموذج وحيد وفريد من الساعات التي تدار بالطاقة المائية، وذلك بجامع القرويين بفاس صنعت بأمر من السلطان أبي سالم بن سلطان أبي الحسن المُتَوفَّى 762هـ/ 1361م.
والاجتماعية والتربوية الرسمية والخاصة.
©المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى©
المواضيع المتشابهه
-
بواسطة hamida في المنتدى المواد العلمية و التقنية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 09-16-2014, 01:05 AM بتوقيت الجزائر
-
بواسطة madiha في المنتدى الأسرة التربوية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 09-05-2014, 05:14 PM بتوقيت الجزائر
-
بواسطة mira في المنتدى عالم حواء
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 09-03-2014, 08:30 PM بتوقيت الجزائر
-
بواسطة mira في المنتدى تجهيزات منزلية
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 07-17-2014, 04:04 AM بتوقيت الجزائر
-
بواسطة mira في المنتدى ديكور و ترتيب البيت
مشاركات: 0
آخر مشاركة: 07-16-2014, 05:19 PM بتوقيت الجزائر
 ضوابط المشاركة
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
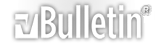



 رد مع اقتباس
رد مع اقتباس